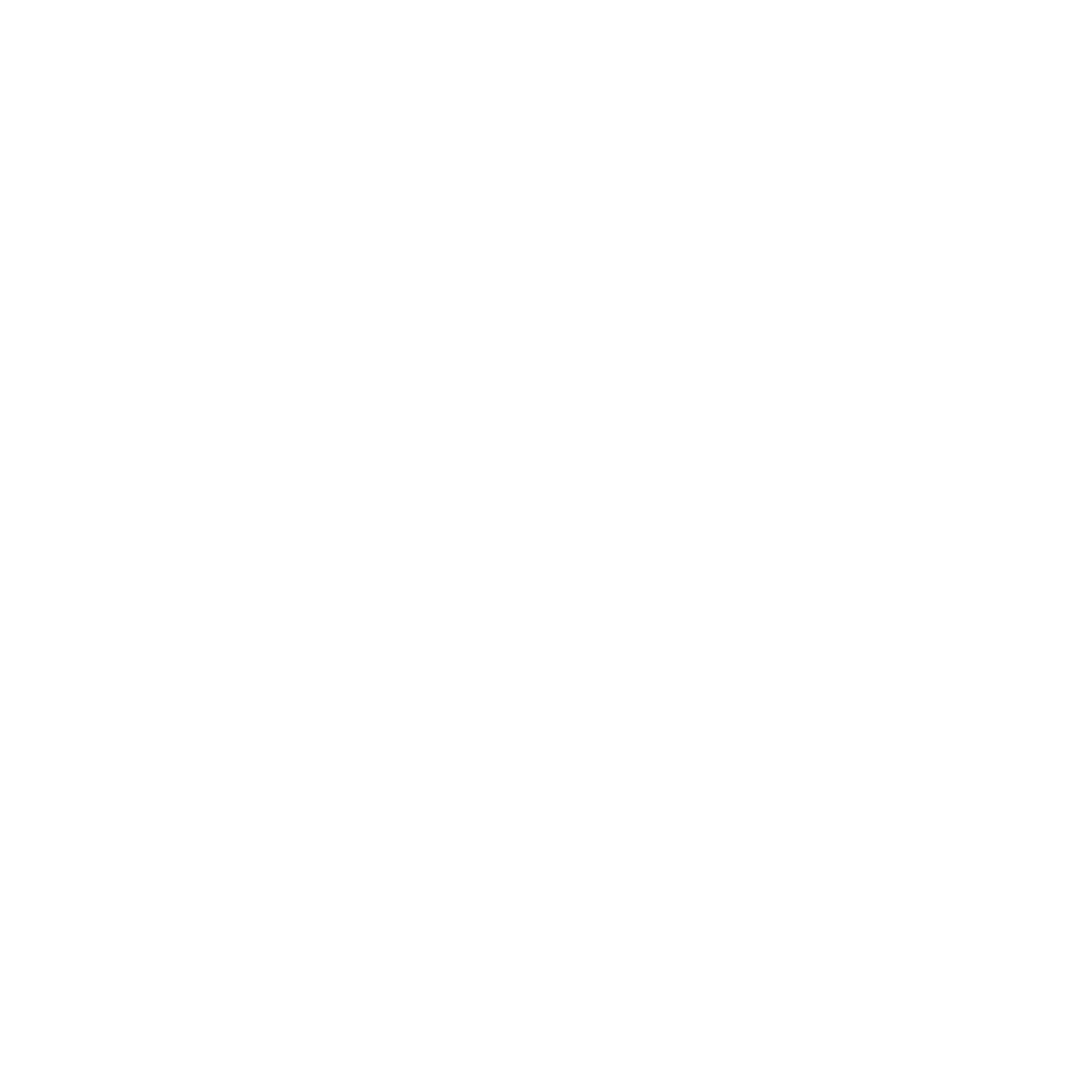يكشف تاريخ التابو مسيرة صناعة الأفلام، المنتَجة محليًا أو المستوردة، من الأندرجراوند إلى سينمات العالم، ومن المنبوذ إلى الأكثر رواجًا على المستوى التجاري. ولكن ثمة تاريخ آخر من المواجهة بين الرقابة والفن، باعتبار أن أعظم الأعمال الفنية تمت تحت وطأة أنظمة استغلال وقمع.
لا نريد في هذه المادة تبرير الرقابة بأي شكل من الأشكال، وإنما نرصد جانبًا من الأسباب التي مكنت صناعة السينما من الصمود والاستمرار، مع دراسة الظروف التي دفعت الفنانين إلى استخدام الرمز والاستعارة للنجاة من سلطة الرقيب، فعلى عكس عالم الرواية الذي يمثل القمع فيه سببًا كافيًا للشهرة والانتشار والذيوع -«دكتور زيفاجو» مثالًا، فالرواية مُنعت من النشر في الاتحاد السوفييتي، فهربت إلى إيطاليا ونُشرت هناك عام 1957 ليفوز «باسترناك» بجائزة نوبل للأدب، وجعل السينمائي الأمريكي «ديفيد لين» منها فيلمًا سينمائيًا عام 1965 (ولم يكن هناك إنترنت)- لا يتوفر هذا الخيار في السينما، فما إن يُمنع الفيلم من الظهور، في حال سيطرة الدولة على الإنتاج والتوزيع، حتى يختفي نهائيًا، وهناك أفلام عُرضت مرة واحدة ومُنعت بعد ذلك إلى الأبد، وهكذا.
تاريخ الرقابة على السينما
تتفاوت طبيعة المقدس والتابو في السينما وفقًا لثقافة كل بلد والقوى المؤثرة فيه، فمنذ «آيزنشتاين» في روسيا إلى «شورم» في تشيكوسلوفاكيا و«ماكافييف» في يوغوسلافيا، وانبثاق الحركة البولندية على يد «بولانسكي»، و«سكوليموفسكي»، و«هاس»، و«مونك»، وميلاد السينما التشيكية في تجارب «شورم»، و«نيميك»، و«يوراسيك»، و«فيرا كتيلوفا»، وكذلك ظهور أهم سينما في البرازيل، الحركة الجديدة -سينما نوفو- في ظل نظام يعتمد في بقائه على القمع وتكريس الفقر، تشترك جميع هذه التجارب السينمائية في أنها خرجت إلى الشاشة تحت سيطرة أنظمة عسكرية واستبدادية.
كانت السينما في العهد السوفييتي تصدر عن الجهاز الدعائي للدولة، بحيث صارت أفلام ذاتية وروحانية مثل أفلام «تاركوفسكي» أو شاعرية بطابع فلكلوري مثل أفلام «باراغانوف» بمثابة خيانة للدولة. وبرغم تغير ظروف صناعة الأفلام في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تقلصت الخطوط الحمراء حول المثلية والنقد السياسي في الوقت الحاضر. ويمكن للمرء اليوم أن يُعجَب بإصرار المخرجين الإيرانيين على تنفيذ أفلامهم الجديدة وإن ذهبوا إلى السجن لاحقًا، كما حدث مع «سعيد روستائي» و«جعفر بناهي» مؤخرًا. أما في عديد من الدول العربية، يكفي ظهور قطعة ملابس داخلية كما حدث مع منى زكي لإثارة جدل واسع.
الاحتيال على الرقابة
استطاع كثيرون من المخرجين تمرير مواد جريئة تحت الرادار باللعب على ثنائية الجنس والسياسة، كما يكشف المخرج الأرجنتيني «أدولفو أريستارين» -وهو مثل كثير من جيله- في حديثه إلى المؤرخة الأمريكية «آنيت إينسدروف» لمجلة «سينياسْت»، ففي أعقاب موت الرئيس «خوان بيرون»، عاد أريستارين من منفاه الاختياري إلى بلاده، على أمل أن الأمور قد صارت أحسنَ، لكن موجةً دمويةً اجتاحت البلاد بشكل أعنف من سابقاتها، عُرفت حينها بالـ«غِيرّا سوسيا»، فكان من المستحيل صنع أفلام سياسية، لاسيما أن أفلام أريستارين “سياسية” بطريقةٍ أو بأخرى.
جاء فيلمه الأشهر «حان وقت الانتقام» الذي قام ببطولته نجمه الأثير «فيديريكو لوبي» في وسط اقتتال مستمر، لكن أريستارين يعترف بأنه أخرجه كما أراد ولم يتعرض لقسوة مقص الرقيب. كان أريستارين يفهم جيدًا ذهنية الرقيب حينها، فصوّر مشاهد جنسيةٍ طويلة وفائضة قضى معها الرقباء خمسة أيامٍ يستجوبونه. لم يتطرقوا للسياسة أو الأيديولوجيا. كانوا يسألونه فقط عن المشاهد الجنسية. اقتطع بعض المشاهد -«صنعتُها أطول مما ينبغي» كما يقول- ونجا الفيلم من الرقابة ليصبح واحدًا من أهم كلاسيكيات السينما الأرجنتينية.
تتكرر تلك الحيلة “الجنسية” -إن أمكن القول- في كثير من الأعمال العربية، حيث يروي المخرج صلاح أبو سيف أنه استطاع تمرير فيلم «الأسطى حسن» الذي ينتقد الظروف الاجتماعية بالإكثار من مشاهد القبلات بين فريد شوقي وهدى سلطان، ولكن الرقابة فرضت عليه أن يكتب جملة «القناعة كنز لا يفنى». وتكررت هذه الحيلة في فيلمه الآخر «حمام الملاليطي» ، ويبدو أن المخرج خالد يوسف قد استلهم هذا الأسلوب في فيلم «الريس عمر حرب» وبقية أفلامه التي استغلت الحرية النسبية في مطلع الألفية الجديدة في مصر.
الشيء نفسه يمكن أن يُقال عن فيلم «البرتقالة الآلية» لـ«ستانلي كيوبريك»، حيث عمد إلى تضخيم أماكن الأعضاء التناسلية وبث مشاهد جنسية في دراما جريئة في نقدها الاجتماعي والسياسي بالرسائل والأفكار والرمزيات والمشاهد العنيفة تحت أنظار الرقابة البريطانية، ومن ثم حَذَفها لاحقًا كي يتيح لفيلمه أن يُعرض تجاريًا، ما يدفعنا إلى السؤال، إذا كانت بعض هذه المشاهد الجنسية تُحذف من الفيلم، دون الإخلال به، لماذا توضع من الأساس؟ الحقيقة أنه ليس دومًا بسبب الاحتيال على الرقابة (من اللازم التنويه بأن هناك استخدامات أخرى غير تجنب الرقابة السياسية، مثل توظيف عنصر الصدمة والإثارة والدعاية الرخيصة، وهو ما فعله المخرج هاني أبو أسعد في فيلم «صالون هدى» بحذف مشهد العري من العرض في السينمات العربية واكتفى بعرضه في فرنسا).
جماليات الرمز
توطدت علاقة قديمة بين استخدام الرمز واضطراب الحياة السياسية بشكل جلي، فهي حيلة الفنان -أو الفنانة- للتعبير عن رأيه إزاء الهموم المشتركة من دون التنازل عن العنصر الفني. وعوضًا عن المُباشرة في انتقاد حدث ما أو مرحلة ما أو شخصية ما، يُستخدم الرمز. والحاصل أن تضييق الحريات التي دفعت كثيرًا من الفنانين إلى الاستعاضة عن المباشرة بالترميز قد خلّدَ العملَ بشكل أو بآخر، باعتبار أن العمل المطروح لا يخص مرحلة خاصة ولا شخصية معينة، وأننا قد تجاوزنا زمن طرحها، وبالتالي، نستعين بالعمل في كل مرة نجد أننا أمام نفس المأزق.
في الفن الإسلامي مثلًا، بسبب الأحكام التي تحرم الرسم والتصوير بمفهومه العام، استعان الفنان المسلم بالترميز، إذ كان ملزمًا بالابتعاد عن المحاكاة المخالفة للشريعة، فاستخدم التجريد والاستعارة والبنى الهندسية للتعبير عن الأشياء، وهو التكنيك الذي جعل العمل الفني أجمل بكثير ويتم تقديره حتى اليوم. وإلى جانب ذلك، انصرفت الثقافة التي تحظر الصورة إلى تمثيل ذاتها في الكلمات، في النصوص، في أدب فريد، وحسب عبدالفتاح كيليطو، هذه هي الوجهة التي ينبغي منها مساءلة ظواهر مثل السجع والألعاب اللفظية وتقنيات تجويد الخط التي تحاول تصوير النص وتشخيصه.
في السينما، يخلق الترميز أبعادًا جمالية مدهشة، فيتطلب من المُشاهد جهدًا إضافيًا لبلوغ المعنى، فالمجاز هو طريقة لقول أشياء من دون قولها، وكما يقول «أندريه تاركوفسكي»: «في السينما من المهم ألا نشرح، بل أن نتصرّف بحسب مشاعر المُشاهد، وهذه المشاعر التي تمّ إيقاظها هي التي تحفّزه على الفكرة». ويعبّر المخرج «بريسون» عن دور المشاهد في العمل الفني: «لا يمكنك أن توضح كل شيء، لو فعلت هذا لن يصبح فنًا.. الفن قائم على التوقعات».
بعد انتهاء الرقابات المفروضة على السينما الأمريكية، وانكسار تابوهات الدين والعصابات والجنس، ابتلعت هوليوود كثيرًا من صناع الأفلام المستقلين والاستوديوهات الصغيرة داخل منظومتها، المنظومة التي استسهلت صناعة السينما والحياة نفسها بحسب تعبير «وودي آلن»، حيث رسخت النهايات الهوليوودية السعيدة التي تتوافق مع فكرة «الحلم الأمريكي» آلية تناول محددة، وتتفاوت نمطية هذه الآلية بين شركات هوليوود العملاقة في توجيه المُشاهد -المتلقي- نحو الحدث حد التلقين. في السياق نفسه، يرفض المخرج التركي «نوري بيلجي جيلان» صناعة أفلام على شاكلة أفلام هوليوود، وبحسب تعبيره، فإن «مشكلة هوليوود أن الجمهور بات يتوقع أن تعطي له الإجابات كالأقراص، ليس فقط مَن فَعَل جريمة ما، بل دوافع الشخصيات، كيف ولماذا؟ الحياة في الواقع ليست كذلك، حتى أقرب الأصدقاء، لا نعرف على وجه الدقة فيمَ يفكرون. في السينما نريد أكثر مما هو متاح في الحياة، إذ نريد أن نرى كل شيء بوضوح. هذا يعني أن هذا النوع من السينما كذبة، وأنا لا أستطيع أن أصنع مثل هذا النوع من السينما».
هل الحرية شرط الإبداع؟
منذ أواخر التسعينيات، نشطت صناعة السينما في إيران بشكل كبير، وترسخ تقليد ثابت في السينما الإيرانية يعتمد على التعبير بشكل غير مباشر. وبرغم الرقابة الشديدة، تحايل مخرجون مثل «محسن مخملباف» و«جعفر بناهي» و«عباس كيارستمي» و«مجيد مجيدي» على الرقابة باستخدام ممثلين أطفال للتعبير عن فلسفتهم ورؤيتهم، ومن ثم أرسلوا أفلامهم إلى مهرجانات سينمائية أجنبية خارج البلاد حيث حازوا على كثير من الجوائز.
في أحد المؤتمرات، سُئل كيارستمي إن كانت أجھزة الرقابة قد أثّرت في أفلامه، فرد بهدوء قائلًا : «سواء أكانت ھناك رقابة أم لم تكن، فإن أعمالي قادرة على أن تعبر عن نفسھا بطريقتها الخاصة. أیضًا أشعر بأن كلمة الرقابةّ توفر أحیانًا درعًا أو حجابًا نستطیع أن نخبئ خلفه نواقصنا ونقاط ضعفنا، ونحلّ أنفسنا من واجب المسؤولية تجاه أعمالنا». وفي أحد حواراته مع «ميريام روسين» في مجلة سينياسْت، يقول: «أحیانًا عندما لا یكون لدى المرء أي حدود، عندما لا یجد ما یعيقه ویعترض طریقه، یشعر أنه لا یستطیع أن یعمل. إذا كان لدي موضوع لا یلقى صعوبة أو معارضة من الرقابة، فإنني أشعر كما لو لم أفكر فیه مليًا إلى حد كاف. لكن عندما أفكر حقًا في ما أرید أن أفعله، فإنني أمضي إلى ما وراء الرقباء. بإمكانھم منع الأشياء البدائية والساذجة والظاھریة، لكن بإمكانك أن تتجاوز ھذه المرحلة من الرقابة. ذلك ما یجعل الفن أقوى». ويعقب «جيل جيكوب» بالقول: «الثورة الفنية غالبًا ما تحدث في الأقطار المثقلة بالقيود، حيث الفنان لا يكون حرًا. الفن غالبًا يولد من الكبح. من جهة أخرى، عندما تكتشف الحرية من جديد، يكون هناك نقصًا في النوعية لأن الخيار يصبح ضخمًا، ويطرح معضلاتٍ جديدة».
ولعل أعمال فترتَي الثمانينيات ومطلع الألفية في السينما المصرية تكشف لنا أكثر عن العلاقة بين الإبداع والرقابة، ففي النصف الثاني من العقد الأول من الألفية الجديدة، وهي أكثر الفترات تحررًا على المستوى السياسي، استغل صناعُ الأفلام الحرية النسبية لمعارضة النظام في مجموعة أفلام ظهر الاهتمام السياسي فيها أكثر من الفني والاجتماعي، وخرجت أفلام من المستحيل أن نتخيّل بمثل جرأتها اليوم. مع ذلك، لم تحقق تلك الحرية النسبية المؤقتة أفلامًا تقترب من أفلام الواقعية المصرية الجديدة في الثمانينيات رغم كل القيود والضوابط.
خاتمة
من المهم فصل علاقة الرقابة بصناعة السينما عن علاقتها بصنّاع السينما والمجتمع بشكل عام، فمن غير الممكن الإشارة إلى فائدة في الحالة الثانية. ولكن، بعد قرن وأكثر من صناعة السينما، ربما الوحش الحقيقي هو الرقابة المالية، الوحش الذي سيظل حاضرًا دومًا في صناعة السينما، والذي يعمل بوصفه أحد أدوات السلطة للسيطرة على المشهد الفني. وبرغم تغيُّر خارطة الرقباء في العالم، -وإنْ في حدود دول أقل عددًا عما كان في السابق- لا تزال هيمنة الرقيب في البلدان التي تُموَّل فيها صناعة السينما من الدولة نفسها، يتزايد تأثيرها من القمع السياسي المباشر إلى قمع من نوع آخر، وذلك بفرض رقابة قبل الإنتاج أو الامتناع عن التمويل. تتفاوت ظروف كل بلد باختلاف ثقافته والقوى المسيطرة، ولكن يبقى الثابت أنه لولا الرمز الفني، ومخرجين فهموا ذهنية الرقيب، ربما لكُنّا سنُحرَم من تحف فنية. وهكذا، حتى وقت طويل، سيظل الرقيب عائقًا ومحفِّزًا في آنٍ واحد لصناعة السينما.