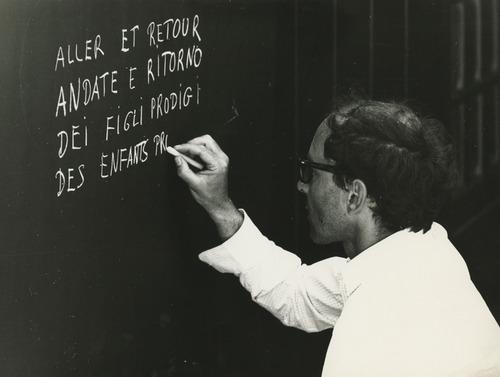يختلف الاكتئاب في غرائبية الشعور وفتور حامله، فتارة يزرع بالمرء نزعة اندفاعية ينفر منها الجميع، وكأنه كهلٌ يهدي أحد الأطفال حلوى في زمنٍ عزّت فيه النوايا الصافية فظنوا أنه خاطِفٌ أو مُعتل، وتارة يعني الانكفاء والانزواء والتقوقع والتقنفذ والإجابات المتصلة بمفردة أو بجملة واحدة. وقد يتطور بشكل خطير ويصبح كلعبة الروليت: قد تنطلق إحدى الرصاصات حين تقرر الطبيعة الضغط على الزناد في لحظة استياء الحظ!
ولكل مرحلة عمرية وظرفية إدراكها الخاص ووعيها المتفرد، فقد تحضر هذه المشاعر السلبية بسبب فقدان شخص أو هجران حبيب أو عنين أدرك علّته أو خسارة لوظيفة أو واقع منفلت، أو حتى أسى ما بعد الولادة. وكلما تعاظمت نوازل الحياة، واستسلم المرء لرِبْق الشدائد، واستفحلت جسامة المصائب، أو تشابهت الأيام، ازداد اكتئابه، وأقل الاكتئاب وعيًا ما سجل حضوره في مرحلة المراهقة النقيضة تمامًا للطفولة التي غالبًا كانت مرتبطة بالإيمان المطلق والتطلع بمنافحة من لا يجفل ولا يحفل بالظروف المحيطة، التي تحتاج إلى الوعي التام بالمنغصات الحياتية. فمن حسن الحظ التلقينات المسبقة، وهذا ما يفسر ضعف القدرة الاستيعابية أثناء حدوث الصدمات المؤدية للاكتئاب. فمن مراهقتي أتذكر الملاحظة التي أبديتها حيال أثر لحرق سيجارة في الخيمة المستأجرة لعزاء والدتي، والذي أدركته سابقًا في عزاء والدة صديقي، وكأن هذه المصادفة التي وضعتنا بنفس الخيمة تستحق المشاركة!
وهذا المشهد يشابه ما قاله الشاب "كونراد" لطبيبه النفسي معبرًا عن شعوره بعد خسارته لأخيه "باك" في فيلم "أناس عاديون" الصادر عام 1980م للمخرج "روبرت ريدفورد". قال:
«جاء أبي إلى غرفتي لمواساتي ولم يكن يعرف ما عليه أن يقول، وهذا بعد وفاة "باك" مباشرة. أتى وجلس على سريري بالقرب مني ووضع ذراعه حول كتفي. جلسنا هناك فحسب. أتذكر أنني كنت أشاهد حذاءه. كان الحذاء مقلوبًا على جانبه بسبب قدمه المعقوفة للداخل. كنت أفكر، إنه قلق ومتوتر جدًا. الحذاء سيتمزق، وأعلم أن عليّ أن أشعر بشيء ما، لكنني لم أعرف ما علي أن أشعر به، وأخذت أتذكر ما يقولونه على التلفاز، كل تلك الأمور مثل: "أوه، لا لا، يا إلهي" لكنني لم أقل هذا لأنني لم أشعر بالحزن».
في كلا الموقفين -الواقعي والمتخيل- نستشف بلادة المشاعر التي لم تستطع الإلمام بما حصل، فالسذاجة كانت عنوان بداية مشوار المرحلة التجاوزية إن صح الوصف، كما لا يمتلك أغلب مَن في هذا العمر ذاكرة جدلية ضغينية، كما حصل مع الشاب "تشارلي" من فيلم "مزايا أن تكون خجولًا" حين دفن ذكرى خالته الراحلة التي كانت تتحرش به بصورة غير مباشرة، مستحضرًا حبها وعطفها عليه فحسب. ولكن الجيد في هذه المرحلة هو القوة على انتشال الذات من هذا الوحل، كونها تحضر في هيئة صدمةٍ عاطفية لا حزنٍ محض، وهذا يتم إرجاؤه للذكريات التي كلما ازدادتْ زاد الأسى وكلما قلّتْ تسهّلتْ عملية التجاوز، دون التعريف بأنه العمر الذي يقال فيه: «القادم أكثر من الذي مضى» على عكس مرحلة النضج التام -التي لم يتبقّ منها كثير- وعملية الانغماس الكاملة التي قد تصل بنا إلى الإبداع في تجسيد الاغتمام، كابتكار خطة تتويجية بديلة عوضًا عن الخطط التي لم تُنفَّذ بسبب الظروف الجبرية، وكأن الكبار يعيشون مرثيتهم في واقعهم المرتج، غير متصالحين مع فكرة الفقدان، مما يقودهم إلى محاولة إنهاء وجودهم من على الأرض، ولكن بطريقتهم المميزة بعدما أدركوا حياتهم غير المميزة!
في فيلم "إنها حياة رائعة" الصادر عام 1946م للمخرج "فرانك كابرا" نجد أن الاكتئاب مرتبط بالخسائر والأحلام المبددة، فالبطل "جورج بيلي" كانت آذانه مستنفرة على الدوام وتترنم لأصوات كان يعتقدها هي الأكثر إثارة، مثل صوت المرساة، ومحرك الطائرة، وصافرة القطار!
كان يحلم بترك بلدته الصغيرة "بيدفورد فولز" لاستكمال دراسته ولمشاهدة العالم، لزيارة فرنسا وإيطاليا واليونان ومعبد البارثينون ومدرج الكلوسيوم، حتى وجد نفسه لاحقًا مكبلًا بالظروف التي كانت تُعمّق من ارتباطه لبقعته الجغرافية، ظروف كانت أقوى وأكثر بكثير من تلك الأسباب التي كان يذخر من أجلها المال، ليقرر على إثر ذلك إلقاء نفسه في اليم من على الجسر، ليجد بالأسفل رجلًا يحاول النجاة بنفسه، فيساعده، ليتبين لاحقًا أنه ملاك بلا جناحين، بهيئة رجل، أرسله الله له ليثنيه عن فعلته، وليريه -بوعظية الخضر- كيف سيكون العالم من دونه، موضحًا مدى أهمية وجوده لسكان البلدة ولعائلته، ومدى تأثر الناس به!
ولكن ما أثار حيرتي هو الفكرة من ابتكارية القفزة أو التحليق من على الجسر، أو مثلما أسلفنا القول: «لعبة الروليت» فهي عمليات مميزة ودرامية أكثر من اللازم. ولطالما تساءلتُ حيال أخلاقيات مبتدع هذه الحيلة التي استُخدمت في الذاكرة التلقينية للجسد: هل سيحمل -مبتدعها- وزر جميع من انتحروا بسبب براعته السينمائية أو الأدبية؟ فهذه الحذاقة بالنسبة لي أشبه بلغز الرجل الذي وُجِدَ مشنوقًا بسقف إحدى الحظائر دون وجود كرسي أو طاولة ليركبها، ما عدا أرضًا مبللة فُسِّرت لاحقًا بوجود قطعة جليدية كبيرة ذابت بعدما استخدمها كطاولة لإنهاء حياته، أو حتى وضع الثلج وقنديل البحر السام في حوض الاستحمام كما حصل في فيلم "سبعة أرطال"، ليبقى جسده سليمًا وقابلًا للتبرع بالأعضاء.
هل بالضرورة المكتئب مبدع؟ وهل المبتدع هنا مكتئب؟
من استلهم هذه الأفكار الكئيبة المرعبة؟ هل عززتها الأفلام؟ أم أن الأفلام استلهمتها من الواقع؟ نعود بهذا التساؤل لجدلية من جاء أولاً: الدجاجة أم البيضة!؟
سأقول : «الدجاجة تزوجت بصخرة ثم باضت!» تفسيرًا لهذا الإبداع الإشكالي التراكمي الذي وُظف في غير محله بتعقيد لا يدرك -لاسيما المرتبط بالجسور وفكرة التحليق- كون الجسر عبارة عن آلية انتقال بين ضفتين، وكأن الوقوف على أطرافه برزخ يحثك على تأمل حيرة الخيارين، ما يقودني إلى حكاية جسر "البوابة الذهبية" في ولاية كاليفورنيا، المطل على خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ، والفيلم الوثائقي "الجسر" الذي أثار ضجة أخلاقية عام 2006، الفيلم الذي أخرجه "إيريك ستيل" مستغلًا الجهود المبذولة لوضع حواجز مانعة للانتحار على الجسر بعدما قدّرت دراسةٌ عددَ المنتحرين منه، حيث بلغ عددهم 1200 شخص حينها منذ افتتاحه، ليثبّت كاميراته على طرق المارة من كلا الضفتين، ليحصل على لقطات انتحارية فعلية، ليدمجها بالمقابلات مع أصدقاء وعائلات الضحايا وشهود العيان من دون علمهم المسبق بأنه صوّر آخر لحظات لأحبائهم الراحلين، حيث بلغ عدد الضحايا المصوَّرين في فيلمه 24 رجلاً وامرأة. وعلى عكس الأفلام السينمائية التي كانت تتهم الليل بتسميم الأفكار، كانوا يقبلون على هذه العملية في وضح النهار وفي ساعة الذروة، وهذا الانحدار النفسي أقرب إلى وصف الكاتب أحمد خالد توفيق حين قال:
«الاكتئاب في الثالِثة عَصرًا لَيس كَالثالِثة فَجرًا، فَرق شاسِع بين أنْ يَنحشر الاكتئاب وَسط انشغالك ورغم تَعبك وبين أنْ يَجِدك وَحيدًا في فراشك تُفَكِّر.. الأمر مُختَلِف».
وأكثر من لفت انتباهي في هذا الفيلم الكئيب هو الرجل المتأنق بالملابس السوداء والسترة الجلدية، الأقرب إلى نجم روك أند رول بشعره الطويل ونظارته السوداء، حين جلس أولاً على حافة الحاجز معطيًا ظهره للبحر وكأنه سيمارس رياضة السباحة الفَراشية في غطسته البهلوانية من أعلى المنصة، ليحلق لمدة أربع ثوانٍ بالتمام بسرعة 75 ميلًا في الساعة، ولعل الطريق كان طويلًا عليه كما علّق أحد المقبلين حين تأمل القاع قائلًا: «يا له من طريق طويل للوصول للمياه».
ولكنه كان -وبرأيي- مشهدًا من مشاهد الذاكرة المدجنة سينمائيًا. وبعيدًا عن كون الاكتئاب نصفه وراثي ونصفه الآخر بيئي، استحضرت بعد انتهاء الفيلم كلامَ مريضٍ -قرأته في كتاب "جنون من الطراز الرفيع"- ارتعب من إدراكه حين تأمل الفكرة، فقال لطبيبه بعدما رفض الانصياع للصوت الذي بداخله: «إنها تجربة مرعبة، معرفة أن شخصًا سوف يقتلك، وإن هذا الشخص هو أنت».
ولعلي استجلبت من سلسلة استحضاراتي بعد الفيلم جميع من نجوا أسوة بهذا المريض الذي أنقذه تأمله، والذين رصدت السينما سيرتهم الذاتية ولكنها غفلت عن أهم حدث في حياتهم، وأقصد حدث النجاة من سموم الاكتئاب، مثل "مارتن لوثر كينغ" الذي حاول الانتحار مرتين بسبب اكتئابه وهو بسن الثالثة عشرة، فقد قفز مرتين من الدور الثاني حتى وجد من يؤمنون به فأصبح ذا حلم، أو "غاندي" الذي ضاقت به الحياة حتى بحث عن بذور الداتورة المسمومة فلم يستطع أن يبتلع أكثر من بذرتين فأنجاه القدر ليحقق حلم الهند بالاستقلالية!
أو حتى "لينكولن" الذي أنقذه أصدقاؤه حين نشر -قبل أن يكون رئيسًا- قصيدةً عن الانتحار، إذ كان يتجول ببندقيته وحيدًا بالغابة بعد وفاة حبيبته ليحسم أمر وجوده، حتى تحسنت حالته وأصبح لاحقًا رئيسًا!
أو حتى "تشرتشل" الذي صرح لطبيبه "اللورد موران" بأنه لا يحب الوقوف على حافة الرصيف عندما يمر القطار، وفي ذلك دلالة على الأفكار المسمومة حين نستسلم لها!
برأيي، القصص والأفلام والحقائق لا تُظهر أن الانتحار الذي يتسبب به الاكتئاب فِعلٌ شجاع أو حتى جبان، بل تُظهر أن الانسان قد تهزمه ظروف بيئته الأقوى منه وقد يقاومها؛ فالإنسان قد يبلغ من دقة الشعور واتقاد الوعي ما يجعله يلتقط كل ما يحيط به من وباء الواقع، ليضخمه في نفسه أضعافًا مضاعفة، وذلك بسبب رؤية حقيقية أو حتى مشوهة لعالم مظلم شكّل به نزعةً قهريةً ويأسًا، فالاكتئاب والإحباط هنا لا يتولدان بالضرورة عن بشاعة الواقع، وإنما عن وضوحه المرعب الأشبه بالحاسة السادسة التي عذّبت صاحبها بعدما اطّلع على الأصوات الداخلية.
ما أدركته من الأفلام "المنقذة" هو أن الملاك قد يحضر بلا جناحين، لينقذ حيوات عبثت بها الشياطين، كالذي كان مع "جورج بايلي" في فيلم "إنها حياة رائعة": الغريق الذي كان منقِذًا. الأفلام وضّحت لنا أن هناك كفًا لابد لها من أن تربت على كتف، كفًا لإنسان يؤمن بالتصالح ويدفعنا لمرحلة ناضجة فكريًا مقاربة لفكرة، ندرك به التعاطف الوجداني والشعور بمحنة الآخرين، وأقصد "المكتئبين".